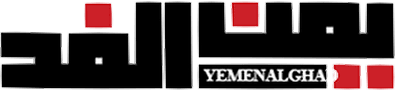عن فبراير.. النتائج ماثلة

وكان لا بد أن يختلف، هناك في أول الطريق وهنا في المنحدر.
في أول الطريق خاطر كثير من الناس، ونزلوا إلى الشوارع، واعتصموا في الساحات والميادين، وواجهوا الموت بشجاعة وتصميم.
وأقول الناس على رغم الوصف الشائع لما جرى في 11 فبراير 2011، بأنه ثورة شبابية، ذلك أن الناس خرجوا من كل الأعمار مع غلبة للشباب وطول حضور، كما هو الحال في كل الدنيا وعبر التاريخ.
مقابل هؤلاء ثمة من لم يخاطر وينزل، ولكنه شارك بالدعاء والتمنيات، وهناك غيرهم تمنوا على العكس أن يعود الناس إلى بيوتهم من حكمة أن الفتنة نائمة.
ومن الوهلة الأولى، وقبل أن يتكشف أن الثورة تتعرض للغدر، أو أن مؤامرة وراءها (كان البعض يعرف اتصالات اليهودي الفرنسي هنري ليفي بمن سيكونون شيوخ الربيع العربي)، تملك الشك بعض من اشتغلوا بالعمل السياسي من أن ما يجري لا يمثل ثورة حقيقية، لأنها لا تملك شروط النجاح كما ترويها الأدبيات اليسارية التقليدية، وتؤكدها الخبرة الإنسانية. فليس هناك حزب ثوري ولا نظرية ثورية ولا قيادة ثورية.
إن الثورة في تعريفها البسيط علم تغيير المجتمع، ومن غير ذلك فهي قفزة في المجهول.
وقد تبين ملمح العبث في ما جرى من الشعار الكسيح الذي كتب على اليافطات ورددته الحناجر، هنا في اليمن، كما في البلدان التي سبقت، والتي تبعت إلى ما سمي الربيع العربي.
ما الذي سيكون بعد رحيل الرئيس وحتى بعد رحيل النظام؟
قليلون طرحوا السؤال.. ومن غير تواضع أقول إنني أثرت هذا السؤال وغيره في كتابات نشرتها صحيفة “الجمهورية” التعزية، من دون أن أنكر أنني نزلت ساحات؛ نزلت الستين مرتين لأداء صلاة الجمعة.
وإذن، فقد تكلم البعض، ولكن وسط الحماس والضجيج والتهاب المشاعر، ليس هناك من أصغى ومن أخذ وأعطى.
إن التوصيف الصحيح أن ما حدث في فبراير كان انتفاضة لم تتطور إلى ثورة، بل إنها كانت انتفاضة مغدورة.
لقد كانت دعوة إلى الهدم.. حسنا. ثم ماذا؟
أي بناء سوف يرتفع مكان القديم؟
لا أحد يعلم.
ثم.. ثم أخذت الملامح تقر حقيقة مريرة، وهي أن أعداء الثورة يقودون الثورة.
إنهم أساطين النظام فرقتهم المصالح واحتكم بينهم العداء.
ومنه برزت إشكالية عجيبة، فالبناء الجديد يستحيل أن يتم باستخدام المتهاوي من الجدران والأحجار.
وحتى لو دار في خواطر القديم أنه سيعيد رص الأحجار المتكسرة فوق رؤوسنا، فإن الأمر ينطوي على استحالة.
خلال الأحداث التقيت الدكتور صالح باصرة، رحمه الله، في مكتبه بوزارة التعليم العالي، وسألته من باب الدعابة إن كان يفكر في الالتحاق بزملائه من كبار المسؤولين الذين غادروا مواقعهم في السلطة، ونزلوا إلى الشوارع بين الناس.
لم تكن شهور قليلة قد مضت على ترؤس باصرة لجنة تقصي حقائق، كلفها الرئيس علي عبدالله صالح، عن مشاكل نهب الأراضي في عدن، وعادت اللجنة وأعدت تقريرا كاشفا وجريئا لأول مرة، وحددت بالأسماء والبيانات والوقائع عمليات استباحة مريعة من قبل أصحاب نفوذ مدنيين وعسكريين.
ويوم سألته عما إذا كان يعتزم الانتقال من السلطة إلى الثورة، أجابني وضحكته تسبق صوته، بأنه لاحظ أن 8 من الـ16 الذين وردت أسماؤهم في تقريره، نزلوا الساحات، فقرر البقاء مع الـ8 الآخرين.
وكان أفصح الأدلة خروج قادة عسكريين كبار، وإعلانهم دعم الثورة.
غير هذا، فإن فصيلًا بعينه استولى على المنابر، ومارس الاستبداد والقمع المعنوي والنفسي ضد الآخرين، ولم تغضب قيادات الأحزاب وتلفت نظر قيادات الشريك إلى خطورة ممارسات عناصره في الساحة.
وكان هذا الحزب هو الوحيد الذي أقام غرفة عمليات مركزية وغرفا مساعدة في المحافظات والساحات، أدار منا المعركة وفق مخطط متقن، فيما تصرفت القوى الأخرى باستخفاف، واكتفت قيادتها بزيارات خاطفة تشجيعية واستعراض.
بعد ذلك ذهبوا إلى الرياض، ووقعوا على المبادرة الخليجية، من دون أن يعودوا إلى الناس الذين يواجهون الموت في الميادين والشوارع، وأغلب الظن من غير أن يناقشوا المبادرة في الهيئات الحزبية.
وكانت المبادرة في حقيقة الأمر هي الفخ القاتل.
ولقد شعر المعتصمون وأدركوا أنهم تلقوا طعنة في الظهر.
من الطبيعي، والحال كذلك، أن تحدث الاتفاقية ارتباكا في الصفوف، وبلبلة عاد بسببها أكثر الناس إلى بيوتهم غاضبين، بينما لم يستطع من حاول الاستمرار أن يصمد طويلًا.
وتوالت الحوادث من تولية عبد ربه منصور هادي، إلى سقوط صنعاء في أيدي الحوثيين، حتى اشتعال الحرب وما تمخض عنها وزاد إليها.
والآن في المنحدر ما يزال الناس مختلفين.. البعض يعتقد أن 11 فبراير مثل كارثة حقيقية، ولا يقتصر هذا الرأي على الذين عارضوا الحدث من البداية، بل إن بعض من شاركوا فيه لا يخفون ندمهم.
مقابل هؤلاء ثمة من يحتفل بالمناسبة من منطلق أن الشعب تحدى وحاز شرف البطولة، وعندهم أن الثورة أزاحت الرئيس السابق بعد أن لم يقدر عليه أحد خلال ثلث القرن.
وفي السياسة، ليست الأعمال بالنيات، وإنما بالنتائج.
وحين تستثنى الأعمال التي يغلب فيها السلاح، فإن الهزيمة تصبح معقولة ومنطقية إذا تلقاها الثائرون من النظام.
أما أن تأتي الهزيمة من الثائرين، أو من عناصر في النظام ركبت فوق أحصنهم، فهي سذاجة يتوجب الاعتراف بها.
والعجيب أن أسوأ من في النظام هم الذين ظهروا على واجهة فبراير، ومع ذلك لم يتنبه الذين كانوا في وجه الخطر.
وأحسب في النهاية أن 11 فبراير فوت على اليمنيين ثورة حقيقية كانت شيخوخة النظام تحرض عليها.
والحق أن الذين لا يريدون لليمن أن تستيقظ، وللعالم العربي أن يصحو، استخدموا خمائر الثورة في صناعة ثورة مضادة.
وأقول ثانية، في السياسة.. إنما الأعمال بالنتائج.