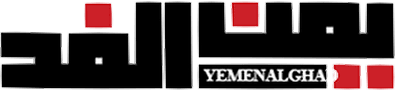في كتابيه حول “الفتنة الكُبرى” توّغل عميد الأدب العربي “طه حُسين” في جذور الصراع الذي تحوّل إلى فتنة بين المسلمين، أدت إلى تجرؤ بعض الصحابة للتحريض على قتل الخليفة “عثمان بن عفان” بعد رفضه الانصياع لرغبتهم بخلع نفسه من الخلافة .
وصمتهم إزاء تبرير قاتليه بتكفيره ، والحيلولة دون دفنه في مقابر المسلمين.
وكان من تبعات ذلك انقسام الدولة في خلافة “علي بن أبي طالب” ومحاربته برفع “قميص عثمان ” حتى قُتل غيلة بطعنة من أحدهم حافظ للقرآن.
ولقد جسّد الكاتب المصري إبراهيم عيسى تلك الحقبة في رواية بديعة رغم بشاعة أحداثها عنوَنها بـ”رحلة الدم” .
أضاف “طه حسين” إلى “الفتنة الكبرى” كتاباً ثالثاً كرّسه لسيرة “الحُسَيْن بن علي” يخلص القارئ لهم إلى استنتاج مفاده أنّ انقسام المسلمين بدأ بتواطئهم على قتل “عثمان” وتوظيفهم للدين في إدارة الصراع على الحكم.

ونتيجة لذلك ظهرت مذاهب سُنية في خلافة العباسيين تُحرِّم الخروج على الحاكم وخلعه، وإن كان فاسقاً وفاجراً، وتُجرِّم شتم ولعن أطراف تلك الفتنة، وإقحام الدين في التنازع على السُلطة ، مع توقير وإجلال آل البيت ومنحهم خُمس الخُمس ، في خطوة هدفت للمصالحة والتقريب بين المتنازعين.
الطريف أنّ من يقرأ “الفتنة الكبرى” سيتضح له أنَّ “ثورات الربيع العربي” بحشودها وشعاراتها اُستلهمت منه رغم مُضي 71عاماً على تأليفه . وقد تنتابه هواجس التصديق بنظرية المؤامرة عندما يفاجأ بأنّ خصوم “عثمان” كانوا يُوصفون بـ”الثوار ” ، وينعتونه بـ”المخلوع ” ، ناهيك عن نصبهم “الخيام” في ساحة خارج المدينة ، وزحفهم بها من تلك الساحة إلى قُبالة منزله، وتكفل “طلحة بن عبيدالله”، وهو من أثرياء الصحابة، بطعامهم وشرابهم .
تأسيساً على ذلك، تخيلوا كيف كانت صلاة المُسلمين طيلة ثمانين عاماً في مساجد تُختم فيها خطبة الجمعة بلعن علي وشيعته، وعلى النقيض جوامع ترد عليهم بهجوم مضاد في أماكن خارج سلطة الخلافة المركزية، وأصبحت المنابر وسيلة يقيس بها الحاكمون ولاء رعاياهم، حتى جاء عُمر بن عبدالعزيز، فألغى تلك البدعة السفيهة ، فيما لم يتخلّ الشيعة عن أحقادهم وسبابهم.
ولا تزال تلك “الفتنة” تحوم فوق رؤوسنا حتى الساعة . وأرجو أن نتجاوزها قبل قيام الساعة .