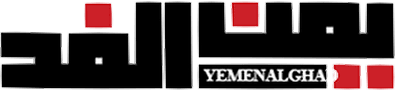سنوات من التآمر!!
لم يتوقع أغلب اليمنيين، وبضمنهم قيادات الدولة، والأحزاب السياسية، أنّ الحرب قد تزيد عن بضعة أشهر؛ فاستقبلوها كـ”شرٍ لا بُدَّ منه” بالبشرى والابتهاج.
وظلوا خلال الأسابيع والأشهر الأولى يعُدُّون الساعات، ويحصون الأيام، ترقُباً لانتهائها وفقاً لأمانيهم.
لكن توقعاتهم خابت، وحساباتهم ذهبت أدراج الرياح.. ومع انقلاب الأيام إلى شهور.. والشهور إلى سنوات.. أصيب المُحتفون بالحرب بخيبة أمل، واستولى عليهم اليأس.. وها هي تُنهي الثُلث الأول من عامها الرابع، وقد تناسلت أطرافها.. وتشعبت دون حسمٍ، أو بارقة أمل بنهاية محددة.
من محاسن الحرب، والطبيعي أن ليس لها محاسن- أنّها نبهت السياسيين، على اختلافهم، لحجم الكارثة التي أوقعوا فيها البلد.. لا فرق بين من أسقط النظام -منهم- عن حقدٍ وعمد.. أو عن غفلة وانسياق وراء أوهام الجماهير المُخدّرة بشعارات السلمية الزائفة في مجتمع قبائلي تحكُمه العُصبويات.. وبين من خَطّط للنيل والانتقام من خصومه.
بل إنّ الغافلين في ظني تسببوا بالضرر الأكبر، لأنّهم توهموا بأنّ مُجرد رفعهم لشعارات الدولة المدنية، والهتاف بها، سيفرضها على الواقع.. وشرعنوا باسم الثورة لتحركات القوى العنصرية المُتربصة بما كان قائماً من “نظام جمهوري” -هو الأنسب والمُتاح، رُغم ما كان من عِلاته ومساوئه- وبالدولة المحكومة بمظهر ديمقراطي، كان بالإمكان تجذيره والبناء عليه.
ولعل من المناسب أن أذكر هنا تعليقاً أدليت به لقناة “الجزيرة” بعد ثلاث ساعات من انضمام “اللواء علي مُحْسن الأحمر” لثورة الشباب في 21 مارس 2011، أكدت فيه بأنّ “انضمامه لساحة الشباب سيخدمه، ويعيد إنتاجه، لكنّه حتماً سيفسد ثورتهم، ويخلط أوراقها”.
وعوتبت من ثوار الغفلة على رأيي الذي ثبُتت صحته، كما لم تعاود “الجزيرة” التواصل معي, مع أنَّه لم تكن لديّ معلومات-حينها- عن سيناريو ومخطط الاستقالات الذي موّلته إمارة “قطر” تزامناً مع استقالة محسن؛ ليجرجر معه المئات من كبار رجالات صالح.
وأحدثوا باستقالاتهم زلزالاً كبيراً.
وأكدت الأيام أنّ الذين تسلموا السلطة بعد المبادرة الخليجية -من أركان النظام الذين ثاروا عليه وأسقطوه بذريعة فساده- كانت مُحصلتهم توسيع دائرة الفساد، والإخفاق في إعادة من استقطبوهم من أعداء الجمهورية إلى وضعهم السابق أو تحجيمهم، ناهيك عن إشاعة الفوضى، وتقويض هيبة الدولة. ولا شيء غير ذلك.
هذه هي النقطة الحرجة.. التي ينبغي أن يعترف بها الجميع ويتفحصوها ملياً, ليتسنى لهم القبض على جمر الحقيقة المُلتهب بنيران الضغائن والأحقاد.. لأنّ ما تلا ذلك: من استدعاء للميليشيات المُتدثرة بلباس الثوار, وفتح المدن أمامها وتمكينها.. كان مُسوِّغ صاحبها الانتقام والثأر, وفقاً لمقولة “الجزاء من جنس العمل” ولَم يخطر في حسبانه أنّ ثأره سيعصف بالجميع, كما في قصة ثأر الفارس العربي القديم (الزير سالم), أو أُسطورة (شمشون) المذكورة في التوراة.. فالثاني هدم المعبد فوق رأسه ورأس خصومه, والأول قضى على معظم عشيرته, ولا يعني هذا “التسويغ” للخطيئة, بقدر ما يهدف لتحليل سببها ووضعها ضمن تسلسلها الزمني وسياقها التاريخي..
في 8 يوليو 2014 قُتِل القائد العسكري “حميد القشيبي” فيما كان “عبدربه منصور هادي” على مأدبة عشاء الملك الراحل “عبدالله بن عبدالعزيز” في قصره في جدة, وخرج منها عائداً إلى صنعاء, بأربعمائة مليون دولار، أخبر الملك أنّها لتسديد مُستحقات المشمولين بالضمان الاجتماعي, وإصلاح الطائرات الحربية التي عفى عليها الزمن (…) والبدء بحملة تطهير بعض المحافظات الجنوبية من القاعدة.. وفور وصوله سحبت وكالة “سبأ” خبر مقتل القشيبي مع التنويه بعدم نشره، وعند الاستفسار، قيل إنّه كان مُتمرداً على أوامر الرئيس.
ولَم يخُفِ وزير دفاع هادي “محمد ناصر أحمد” جذله وسروره أمام جُلسائه, مستذكراً مرور عقدين على حرب صيف 1994, ودخول القشيبي على رأس قواته إلى عدن.. مع أنَّه كان أيضاً نائباً لمدير دائرة الإمداد والتموين العسكري لنفس الطرف وفِي نفس الفترة، والرئيس هادي” وزيراً للدفاع !!
وكان تجمُّع الإصلاح قد أصيب بهاجس “المؤامرة عليه” من السعودية, وأنها تستدرجه بُغية إدراجه في”خانة” الإرهاب, وتطور هاجسه إلى “وسواس قهري” بعد إسقاط الإخوان في “مصر”؛ فآثر مُراقبة الزّفة التي قادها “هادي” لكسب ود “الحوثيين”, رافعاً عقيرته بمقولة كان يحلو له تردادها “عن الضرب بسيف السلم”, ولاحقاً شارك المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في اليمن “عبدالمجيد الزنداني” فيها بطريقته البراغماتية, بـ”وصلة” دينية, استبقها بإعلانات عن اكتشافه علاجاً شافياً من الفقر, شدّ به انتباه الناس, حتى ظهر مُتحدثاً في لفيف من جوقته عن “الزكاة”, و”الخُمُس”!! وكأنّه أراد من خلالها التكفير عن مُصاهرته للقشيبي, بالتقرب للحوثيين بفذلكة عن أحقية “الهاشميين” في خُمس الخُمس من إيرادات الدولة.
وضمن وصلات الزفّة تلك, أصر “هادي” على تمرير الجُرعة السعرية رغم رفض وتحذير “رئيس الحكومة” ونُصح مُستشاريه, وأنزلها ثاني أيام عيد الفطر, بأسعار تزيد عن التي رفضها “باسندوة”, ليمنح بها الحوثيين فُرصتهم التاريخية في قيادة المعارضين المتضررين من رفع أسعار الوقود..
وعند دخول الحوثيين إلى صنعاء.. راوغ الإصلاحيون في الاستجابة للنصائح التي طالبتهم بالمواجهة.. وأجمعوا أمرهم على التعامل المرن معهم عبر وزارة الداخلية التي كانت ضمن حقائبهم واعتبروهم “أصدقاء الشرطة”, وبعد أشهر لم يأبهوا كثيراً لاستقالة هادي فاستمروا في محاورة الحوثيين في “موفنبيك” للتوافق حول شخص “الرئيس القادم”, وحين أعلنت السعودية الحرب تَرَكُوا اليمن لمستقبلها المجهول, وولوا سراعاً للحاق بالعاصفة رُغم تواجدهم الذي كان قوياً في عدد من المحافظات.
وظل وسواس الإرهاب يأكل عقولهم ويطاردهم من مُحافظة إلى أخرى.. حتى تمكّن منهم, فتركوا الحبل على الغارب في المُحافظات التي كانوا مُسيطرين عليها للتنظيمات الموصومة بالإرهاب.. لتقود الحرب بدلاً عنهم, على أسس طائفية وغير وطنية, مُتفرغين لتكديس الأسلحة وقيادة الجمعيات المعنية بتوزيع المعونات, غير آبهين بأنّ ذلك يخرجهم من دائرة المسئولية الوطنية.
اليوم، وبعد ثلاث سنوات من الحب والغرام.. ثمة إصلاحيون يُعبرون عن اشمئزازهم وقرفهم من القوى السلفية ويصفونها بالإرهابية, مع أنّهم دافعوا عنها باستماتة إلى قبل أشهر, وصاروا يقولون إنّها تقاتل من أجل تمكين “الإمارات” للاستحواذ على تعز.. ويؤكدون أنّ النبش في الأيدولوجيات, والاقتتال عليها, لم يَعُد مُقنعاً, وما يجري من احتراب بخصومات وذرائع مذهبية, أو دينية.. تقبَله الناس في الأشهر الأولى من الحرب, على مضض.. وكلام آخر جميل, يدغدغون به المشاعر على شاكلة ما ذكرناه, يحسدهم عليه كبار الفلاسفة.
لكنهم يتناسون أنّهم من فتحوا الأبواب.. وتركوها مُشرعة للسلفية الجهادية, ومن ركب موجتها من البلاطجة.. وأخلوا لها المحافظات التي كانوا يسيطرون على مُعظم مديرياتها, مبررين فعلهم -آنذاك- بتسليط الظالمين على الظالمين, وقال قائلهم “ما للحب المُسوس إلاّ الكيال الأعور”.. كما أنّهم فوضوا “التحالف” الذي تقوده السعودية ومنحوه توقيعاً على بياض لاتخاذ ما يراه مُناسباً, ولَم يضعوا في حُسبانهم خلافه الذي كان كامناً تحت الرماد مع حليفتهم “قطر” -التي لم يستطيعوا الفكاك حتى اللحظة من براثنها المُتغلغلة في جذورهم- وينزعج التحالف اليوم مما يُقال عن دعم فصيلهم التُركي للتواجد القطري في المدينة التي نكبوها بوساوسهم وأحقادهم المريضة.
والحق أنّهم كبّروا وهللوا لاستدعاء هادي للتدخل السعودي , أمّا تراجع فصيلهم التركي من الدفاع عن التحالف إلى الهجوم عليه, فيؤكد أنّهم يقولون ما لا يفعلون, ويحذقون كثيراً في اللعب على مُختلف الحبال, كما أنّهم كانوا مبتهجين في استثمار القيادات السلفية, ومدوا لهم حبال الود, والأحاديث المعسولة عن القواسم المشتركة..
أيضاً: دعموا وموّلوا كتائب مماثلة مثل “حسم” و”الصعاليك”, وهي مُسميات مسْتَخفة بمفهوم الجيوش الوطنية, وحالهم في ذلك حال الميليشيات من بقايا ومخلفات الصراعات الماضوية المُتكلسة, والمشحونة بالحقد والتوجس من كل ماله علاقة بالدولة المدنية الحديثة..
قبل عامين ونيِّف،كتبتُ مُحذِّراً من انتشار تنظيم القاعدة في مدينة تعز, تحت مُسمى “أنصار الشريعة” وإصداره لنشرة عنوانها “فجر الإسلام” تُوزّع جهاراً نهاراً في أحياء وشوارع المدينة, أهدروا فيها دمي، بهدف ترويعي بعد مُشاركتهم في نهب واحتلال مؤسسة الجمهورية.. باسم المقاومة, وفوجئت بهجوم من ناشطين إصلاحيين لم أكن أتوقعه, أتهموني بالافتراء والتلفيق, واختلاق القاعدة, التي صاروا يُصرحون ويصرخون بوجودها..
وتيقنت يومها أنّهم مُصابون فعلاً بوسواس المؤامرة, ولا يختلفون عن بقية القوى الإسلاموية, فهم رُبما يخالفونها في الوسائل.. لكنهم لا يختلفون عنها في الغايات.
على ذلك, ينبغي عليهم, وعلى جميع القوى الحزبية الأخرى, الإقرار بما ارتكبوه من أخطاء في حق اليمن.. إثباتاً لمصداقيتهم وجديتهم في الانخراط في يمن ما بعد الحرب, فذلك أفضل من استسهالهم لإشعال الحرائق الصغيرة.. والتآمر على إخوانهم في الدين والوطن.
كما أنّ وجود الإصلاحيين إلى جانب “هادي” يضعهم تحت ظلال شرعيته في أي مفاوضات قادمة, مثلهم مثل بقية المكونات المُدافعة عن شرعيته,ليس أكثر.. لاسيما بعد عجزهم عن هزيمة الحوثيين, الذين صاروا طرفاً وحيداً..
ففي النهاية لابُد من حل ينهي معاناة اليمنيين.
يكفيهم مُطاردة السراب منذُ سبع سنوات عجاف.. وملاحقة ثوار الغفلة الذين أدخلوا اليمن في نفق مُغرقٍ في الظلام , وأول الحل إقرارهم بأنّهم “أُكِلْوا يَومَ أُكِل الثَّورُ الأبيَضُ”، والاعتراف بأنّ “اليمن” لم يجنِ من شعاراتهم, وأحقادهم سوى المزيد من الفقر.. والتمزق.. والضياع.