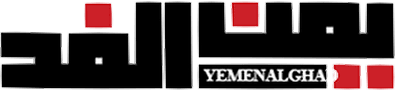لو لم يكن “هاشميا” لما قَتَل
لا يكاد المواطن يطفئ شريط الأخبار عن جريمة تهز كيانه، حتى تطل عليه أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو ثرثرة الأصحاب والجيران؛ مزاد علني افتتح قبل أربع سنوات، ومازال سماسرته يواصلون النداء على بضائعة القذرة حتى اليوم…!!
لا أحد يستطيع إنكار الخطايا البشرية منذ عهد هابيل وقابيل؛ ميراثنا الذي تسلل عبر القاتل لتتناقلها المجتمعات البشرية على مر التاريخ، مواجهة اياها بإقامة المحاكم، وسن القوانين والعقاب الرادع المناسب للحد منها؛ لا يفلت منها سوى متحايل، أو من فر بجلده من تطبيقها..
لا تستثني الجريمة بلد عن آخر. فلا وجود لتلك المجتمعات المثالية سوى في أحلام الفلاسفة ونظرياتهم. ولم تكن اليمن يوما “يوتيبيا الحالمين”، لكنها حاربت الجريمة بكل ما امتلكت من إمكانيات، سواء عبر المجتمع المدني، أم القبلي المسيطر على جزء لا يستهان به من عادات وتقاليد اليمن. وبرغم اعتراض البعض على تصرفات القبيلة ونظامها، إلا أنها حاولت أن تنأى بنفسها عن الالتصاق بمجرم أو قاتل، وتبرأت منهم بوصفهم حالات فردية لا يجوز إسقاطها عليها.
ما استجد اليوم، هي مقابلة الجرائم والفوضى، بتبرير واعذار تعفي فئة معينة من خطيئة ارتكابها، في مهزلة تستنكر مجرد المطالبة بالعدالة..!! وقد استحدثت عبارات غريبة علينا، يجد فيها من يرددها الشفاعة المناسبة للقاتل والمجرم: “ألا تعرفون من هم؟!”، أو: “هل يتساوى دم القبيلي بدم سيد؟!”؛ عبارات استنكارية تجعلنا نقف أمامها كثيراً لنفهم دلالتها ومعناها.
لم تعد الجريمة اذن ملخصة في مجرم عتي، أو غاضب، فقد السيطرة، أو آخر كان ضحية بيئة سيئة. يبقى المجرم جبان خائف من تبعات ما اقترفت يداه، حتى يهتف “أنا هاشمي”، وقد تحولت “السلالة” إلى فكرة قاتلة..! فكرة فارغة المحتوى، لكنها للأسف سيطرت على أصحابها، تسيرهم اينما شاءت، وقد جعلت منهم “آلهة” يمشون على الأرض، ترفض المساس بقدسيتهم التي سولت لهم مشروعية ما يقومون به، واحقيتهم الكاملة لكل ما على الأرض!!..
يعجز الإنسان عن رؤية الحقيقة، ويعمى عنها، حين يصحو ذات نهار وقد وجد نفسه “إلاهً”..
لم يكن اليمني بحاجة لتّصَفُح كتب التاريخ للتعرف على الفكرة القاتلة، أو معرفة مصدرها. فقد شاهدها عن قرب، وشهد على جرائمها رأي العين. مصيبته الكبرى؛ جرأته على رفع أصابع الاتهام بحقها. فلا يحق لمفجوع أو مكلوم أن يصرخ: “لو لم يكن هاشميا، لما قَتَلَ، أو جاهر بجرمه”. فهذه “السلالة”، هي فقط من يحق لها الكلام، بينما تضغط زناد سلاحها..
لا تضغط سلاحها وحسب، بل تفتح أبواب جهنم على تجريمها، والقاء وزر التعميم على “السلالة” بأكملها، متهمة من يقف ضدها أو ينتقدها بالعنصرية واضطهاد الأقلية. قد تتوسع التهم للكفر بما أنزل الله، وقد تضيق قليلا لتتلخص بحقد وحسد يأكلهم بسبب نسبهم “اليمني”، في عملية ابتزاز وترهيب مبطنة، يضطرون فيها للدفاع وتبرئة أنفسهم مما نسب إليهم، وقد أهملوا السبب من وراء طرحهم للرأي أو انتقاده.
نضطر أحياناً لترك اللباقة جانباً، والحديث بكل صراحة وصدق: باسم “الهاشمية” تم الانقلاب على الدولة، وجُند أطفال اليمن وألقيت جثثهم في قيعان الأودية وسفوح الجبال؛ “الهاشمية” الانقلابية، هي من سلبت أراضي الدولة ونهبتها، لتمتد إلى ما يملكه معارضوها؛ “الهاشمية”، هي من رفعت سلاحها وسلطت البلاطجة وارباب السجون ومريديها على المواطن اليمني ليرضخ لها…
لو لم يكن الحوثي “هاشمي”، لما صعد على أجساد اليمنيين، من أجل سرقة احتياطي البنك المركزي، وأموال المتقاعدين، ورواتب الموظفين، وقد اعتبرها حقه ونصيبه الشرعي، ليخرج علينا بعدها بكل وقاحة منظراً عبر شاشات التلفاز يشرح مزايا الولاية، (المنحة الإلهية)، التي خُصَّ بها، ورأى أن ما فيها كافيا لتمرير جرائمه، هانئ البال دون منغصات…!!
لم نكن عنصريون- ولن نكون- حين نشير إلى الوجع؛ لا نعممه، أو نقصد به الإنسان “الهاشمي”، بهدف اجتثاث الأخضر واليابس، بل لرفع أذى الفكرة التي لم نسلم منها. قامت سابقاً ثورة سبتمبر بمشاركة أفراد من الأسر الهاشمية. وفي يومنا هذا، انضم أفراد آخرون إلى الشرعية، انشقوا عن عائلاتهم المنظمة للانقلاب، وعبروا عن رأيهم، رافضين الفكرة، واختاروا بكل شجاعة الوقوف في صف الشعب الذي ينتمون إليه ..
من حق كل يمني، أن يحيا في وطن حقيقي؛ يتساوى فيه أفراده في الحقوق والواجبات؛ يكافئ الفرد الصالح، ويضرب بشدة على يد المجرم الطالح، أيً كان.
وحتى ذلك الوقت، سنمضي في اتهام فكرة “الهاشمية”، ومحاربتها، حتى ننتزعها من جذورها. فليس من السهل تناسي جرائمها في حقنا.