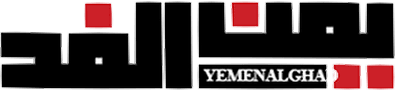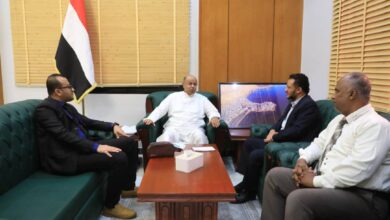متى يصبح التعصب خطراً على الفرد والمجتمع؟

المجتمعات البشرية كافة تضفي على كلمات اللغة التي تستعملها قيماً إيجابية وقيماً سلبية، حتى تصير معظم الكلمات إما محببة، كالحرية والعدالة والمساواة والتسامح، وإما مكروهة ومنفّرة كالتعصب والغلو والعبودية والتفاوت الاجتماعي .. وهذا أمر طبيعي على العموم؛ لأن المجتمع؛ أي مجتمع، نسيج من المعاني والقيم والرموز والعلامات، ربما هي ما تجعله فضاء عاماً. ولكن حين تُبنى على معاني الكلمات مواقف وسياسات، تحوِّل الكلمات إلى عقبات معرفية وأسباب للتجنب والتباعد والتفاصل والنزاع، تمس الحاجة إلى نقد الكلمات مدخلاً إلى نقد الأنساق الفكرية والأيديولوجيات. المبدأ في النقد، هو اعتبار كلمات اللغة كلها محايدة، ومتساوية في القيمة المعرفية، وأن كل متكلم أو متكلمة يضفي أو تضفي على الكلمات معاني خاصة، بحسب الموقع الاجتماعي وزاوية النظر إلى العالم؛ أي إلى المجتمع والدولة، وإلى الإنسان، وإلى المرأة خاصة، وبحسب الخلفية الثقافية للمتكلمة والمتكلم.
التعصب، الذي هو موضوعنا في هذه المداخلة، كلمة مكروهة، ومحمَّلة بحمولات بغيضة، خاصة في هذه الأيام، وهي واحدة من كلمات اللغة لا سبيل إلى حذفها، إذا لم يحذفها التاريخ، كما حذف كثيراً من الكلمات. وهو؛ أي التعصب، حقيقة بشرية لا يخلو منه إلا من لا يفكر ولا يتأمل ولا يعمل ولا يتواصل، ومن ليس له غاية أو هدف، أي الشخص اللامبالي/ـة، واللامنتمي/ـة. لو وقف أي منا أمام مرآة العقل والضمير، لوجد أنه متعصب لفكرة أو رأي أو عقيدة أو جماعة أو حزب، حينئذ يمكنه أن يضع نفسه في موقع الآخر، الذي يتعصب عليه، ويتفهم معنى تعصبه، ويعترف بحقه في ذلك. (أنا متعصب لهذه الفكرة أو المبدأ أو العقيدة، ومن حقك أن تكون متعصباً لما تشاء).
فليس هنالك من فرد (الفرد ذكر وأنثى دوماً) لا يتعصب لعائلة أو عشيرة أو شعب أو أمة، وليس هنالك من فرد لا يتعصب لفكرة أو عقيدة أو مبدأ (أو حزب أو فريق رياضي)، وما أكثر المتعصبين للأعراف والعادات والتقاليد، الموروثة منها أو المستحدثة. فالتعصب بهذا الشمول، ليس خطراً بأي معنى من معاني الخطر، إلا على الفرد، حين يحجر التعصب على عقله وضميره، فلا يرى إلا بعين واحدة، ولا يسمع إلا بأذن واحدة، فيحجب عنه تعصّبه بوارق الحياة وجمالها وغناها، ويحرمه من الخيرات الإنسانية أو ثمار الفكر الإنساني. ولا يصير التعصب والمتعصب خطراً على المجتمع، إلا في ظل سلطة / سلطات مستبدة تمنع تداول الأفكار، وتقمع حرية الرأي والضمير. الخطر هنا لا يأتي من التعصب، ولا من الشخص المتعصب/ـة، بل من الاستبداد والتسلط والقمع وتسميم العلاقات المتبادلة بين الأفراد والجماعات بآليات التفريق والإفساد (فرّق تسد)، وعدم إتاحة أي فرصة لاجتماع الناس والتداول في الشؤون العامة.
على هذا المنوال، قد نبدو من دعاة التعصب، لكن مهلاً، التعصب الذي وصفناه، حتى الآن، له مرادفات دقيقة تكشف عن دلالاته، كالانتماء والاقتناع، والاعتقاد والإيمان والتصديق، ومن البديهي أن يكون الأفراد أحراراً في انتماءاتهم وقناعاتهم ومعتقداتهم وإيماناتهم وما يصدقونه، ومن البديهي أن يكونوا منحازين لها، ولمن يشاركونهم إياها. من هنا ينطوي التعصب، بالمعاني المشار إليها، على إمكانية التطرف، وهنا مكمن الخطر. يولد التطرف دوماً من إرادة الإقناع، بالعنف أو باللين. فكل من يريد إقناع الآخرين والآخريات بأفكاره وآرائه ومعتقداته، ويعمل في سبيل ذلك؛ إذ الإرادة وحدها لا تكفي، هو مشروع مستبد، وهي مشروع مستبدة. (الخطر دوماً يتولد من الاستبداد). وأول الاستبداد هو الاستبداد بالرأي، كما عرفه الكواكبي، في كتابه المهم: “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد”.
التطرف هو مزيج من التعصب والعنف، سواء كان العنف مادياً غليظاً أو رمزياً ناعماً. إرادة “الإقناع” هي التي تولَّد العنف، وتحوِّل التعصب إلى تطرف. هل يراد من الإقناع بالعنف أو باللين سوى فرض عقيدة المتكلم/ـة على الآخرين، والتسلط عليهم والهيمنة على عقولهم وضمائرهم؟ إرادة الإقناع هي إرادة السلطة، في جميع الأحوال. هذا لكي نتنبَّه إلى بنية النظام التربوي والتعليمي، وبنية السلطة التربوية – التعليمية، (المعلمون والمعلمات والمدرسون والمدرسات وأساتذة المعاهد والجامعات وأستاذاتها)، وأثر هاتين البنيتين في إنتاج التعصب الأعمى والتطرف، الذي يشل روح الفرد وروح المجتمع. هذا قبل أن نتحدث عن تطرف الجماعات العقائدية، دينية كانت، كالجماعات المتطرفة اليهودية والمسيحية والإسلامية، أم غير دينية، كالأحزاب القومية والشيوعية.
الفرضية التي تبطن هذا الكلام كله، وتوجهه مفادها أنّ “الدعوة”، في أيامنا، هي التي تحوِّل ظاهرة عامة، كالتعصب، إلى ظاهرة خاصة هي التطرف، المؤسس على العنف، والذي ينطوي على إمكانات الإرهاب، وليس هنا مجال مناقشة الإرهاب. وذلك بتحويل دين عام لجماعة بعينها إلى دين خاص لفئة قليلة من الجماعة، تدعي هذه الفئة أنّها وحدها القيِّمة على الدين والمطلعة على مقاصد الشريعة. هل هناك اليوم ما هو أكثر سخافة وسفاهة من أن تتنطع قلة من المسلمين لهداية المسلمين، أو قلة من المسيحيين لهداية عموم المسيحيين، وقلة من اليهود لهداية اليهود؟ وهل هناك ما هو أكثر سخافة وسفاهة من تنطع قلة من الناس لتغيير العالم، وجعله كما تريد هذه القلة (الطليعة الثورية)، على نحو ما كانته الأحزاب الشيوعية، قبل أن تتحالف مع “الشرائح الثورية من البورجوازية الصغيرة”، كحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا والعراق وغيرهما. وها هي تتحالف مع الطغاة والمجرمين واللصوص، ومع دول ومنظمات طائفية تمارس تكفيراً صريحاً وإرهابا همجياً، كالجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله والحشد الشعبي وغيرها، ناهيكم عن روسيا وكوريا الشمالية والشعبويين في أمريكا اللاتينية.
نتحدث عن “الدعوة” في أيامنا، لا عن الدعوة في الماضي؛ لأننا نعتقد أننا لا نعرف عن الماضي شيئاً أكثر مما هو موجود في الحاضر. فالذين يزعمون أنهم يعيدون “تجربة النبي”، أو “تجربة إبراهيم الخليلِ”، في أيامنا، لا يعرفون شيئاً عن تلك التجربة غير ما ذكرته كتب مشكوك في صدقها، يسمونها كتب التاريخ، وكتب أخرى لرجال يصيبون ويخطئون، يسمونها “الفقه” الذي حل محل الدين. مع أن ميزة الإسلام، التي كان يستقوي بها النهضويون على الكنيسة في الغرب، أنه لا يقبل أي وساطة بين الإنسان والله، وأن كل نفس بما كسبت رهينة.