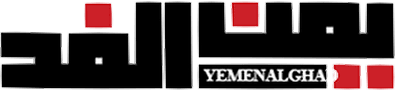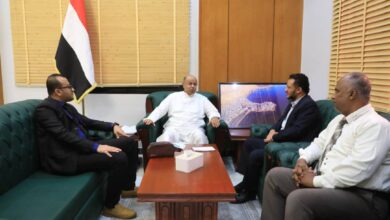الخروج من دوامة السلالة المقدسة
قال لي “مثقف” سلالي مرة: إن الاعتراض على السلالية اعتراض على الرسول الذي جعل الأمر في سلالته القرشية، وقبل ذلك اعتراض على الله نفسه. الله الذي أقر السلالية، واصطفى كل أنبيائه من سلالة واحدة!
عنده حق.. لا مجال لرفض السلالية من منطلق ديني، وبالذات في اليهودية التي تقررت السلالية فيها في نصوص التوراة وبقية أسفار العهد القديم، وإن كانت إسرائيل اليوم دولة مدنية، فلأنها تبنت المواطنة من خارج الكتاب المقدس.
في العالم الإسلامي حدث العكس، تبنى المسلمون السلالية من خارج القرآن الكريم الذي خلا تماماً من أي إشارة لنظام سياسي إسلامي محدد، فضلاً عن جعله حقاً حصرياً لسلالة معينة.
كذلك السنة النبوية الصحيحة، وكاستطراد تاريخي لا بد منه، فإن أقدم دليل لغوي على السادة العلويين والأشراف الهاشميين لا يتجاوز أواخر القرن الثالث للهجرة، وبالتحديد سنة “295هـ”.
في هذه السنة تُوفّي أحد الأشخاص المنتسبين للإمام “علي بن أبي طالب”، ونُقش على شاهد قبره: “السَّيِّد الشَّرِيف معاذ بن داود”. وهذا الشاهد الحجري هو أقدم وثيقة في التراث العربي والإسلامي، لاستخدام هذين اللفظين “السيد والشريف” كلقبين مخصصين بالعرق العلوي، والسلالة الهاشمية.
قبل ذلك، في العصر الجاهلي، والقرون الأولى للإسلام، كان اللفظان يعبران بشكل عام عن المكانة الفردية الاعتبارية لأي شخص قيادي في المجتمع، وحده دون أقاربه وعائلته وعرقه، فكان زعماء القبائل العربية وقادتها هم “سادة وأشراف العرب”.
لا يعني هذا أن هذه الظاهرة السلالية لم تكن موجودة، بقدر ما يعني أنها لم تتجذر لدرجة الانعكاس على اللغة، أما هي نفسها فتعود إلى العصر الجاهلي الذي شهد بداية الصراع المحموم، وغير المحسوم، بين بني هاشم وبني أمية على زعامة قريش التي كانت بدورها تتطلع إلى زعامة العرب، من خلال مركزيتها الدينية المستمدة من علاقتها بالبيت الحرام.
في القرون الأولى للإسلام تم حسم الصراع على زعامة العرب لصالح قريش، ثم حسم الصراع على زعامة قريش لصالح بني هاشم على أساس مركزيتهم الدينية المستمدة من قرابتهم العرقية بالرسول (ص).
ومع ذلك، لم يتم في هذه الفترة خصخصة هذين اللفظين لمعناهما العنصري، في الأوساط الثقافية، وإن كان يُفترض وجودهما وانتشارهما في الأوساط الشعبية، تبعاً لوجود وانتشار مفاهيم ومعتقدات موازية تتعلق بامتيازات دينية واجتماعية وسياسية خاصة بقريش وبني هاشم.
في القرن الرابع للهجرة فقط. بدأ هذا التخصيص يظهر في بعض المؤلفات المعتبرة، نتيجة ترسخ السلالية في الثقافة الإسلامية، وتجذيرها من قبل المذهبين الشيعي والسني، والعمل عليها من قبل السلطات والمعارضات السياسية خلال العصر العباسي.
ترافق ذلك مع دخول الحضارة العربية الإسلامية مرحلة الانحدار العام، وشيوع الثقافة الانعزالية السلبية، وتغلغل العقائد المتعلقة بالتفوق والأحقية السياسية والاجتماعية لهذا الفخذ من القبيلة القرشية.
عوداً على بدء. لا مجال لرفض السلالية من منطلق ديني، رغم كونها ظاهرة عنصرية طارئة دخيلة على الوعي العربي والثقافة الإسلامية، تبلورت بذورها في العصر الجاهلي، وتنامت خلال عصور الانحطاط، كمعتقدات ثقافية وشعبية مزمنة.
الدين، أي دين، ليس فقط الكتاب المقدس، بل كل الظواهر والمظاهر التاريخية الطارئة عليه، والتي تصبح بالتقادم جزءاً من مرتكزاته الثابتة بالضرورة، مع أنه لا أساس لها في مصادره الأصلية.
في العالم الإسلامي بات حق قريش وبني هاشم بالسلطة، حقاً دينياً حصرياً متفقاً عليه، قديماً وحديثاً، من قِبل معظم الطوائف الإسلامية.
الخلاف بين السنة والشيعة، يدور فقط حول معايير ومواصفات هذا الشخص القرشي الهاشمي. أما النظام السلالي نفسه، فمبدأ مقدس عند الجميع.
من هنا تبرز ضرورة الخيار المدني والمرجعية العلمانية، كمخرج حتمي مصيري وحيد للخلاص من أغلال السلالية ودوامة الصراع الطائفي والضياع الكهنوتي السرمدي في العالم الإسلامي.